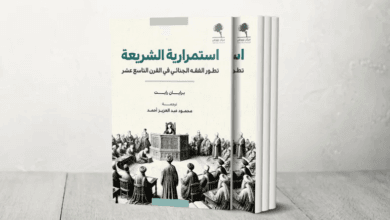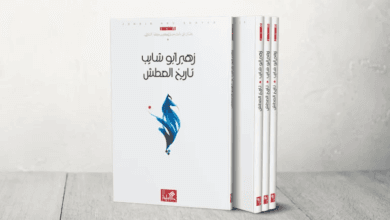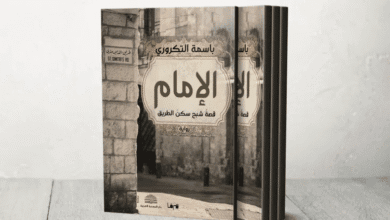الرواية العُمانية بين المحلية والعالمية: “بوصلة السراب” لأحمد الرحبي نموذجًا

تؤكد الرواية العُمانية حضورها المتنامي على الساحة الأدبية العربية والعالمية منذ مطلع الألفية الثالثة، مقدمة نماذج مبدعة استطاعت أن تعوّض عن تأخرها الزمني في مواكبة نشأة الرواية العربية وتطورها في القرن العشرين. ويبرز هذا الحضور من خلال أعمال عدد من الأسماء البارزة مثل: محمد اليحيائي، جوخة الحارثي، زهران القاسمي، محمود الرحبي، بشرى خلفان، وهدى حمد، وغيرهم من الروائيين الذين منحوا الرواية العُمانية مكانة معتبرة على المستويين العربي والعالمي.
هذا الحراك الإبداعي أسهم كذلك في استنهاض النقد الأدبي داخل سلطنة عمان وخارجها، حيث انشغل عدد من النقاد العُمانيين والعرب بقراءة هذه التجارب وتفكيكها، بما أتاح للرواية العُمانية أن تدخل بقوة في نسيج الرواية العربية الحديثة، وتشارك بفاعلية في المنافسة الأدبية التي تشهدها الساحتان المشرقية والمغربية، مدعومة بحضورها اللافت في الجوائز المرموقة.
وقد برزت مؤخراً تجربة الكاتب والقاص أحمد م. الرحبي من خلال روايته بوصلة السراب التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة كتارا 2025، لتشكل علامة مميزة في مساره الإبداعي الممتد بين القصة والرواية والترجمة. الرحبي، المولود في مسقط عام 1971، تنقل في دراسته بين المغرب ومصر وفرنسا وروسيا، واستقر منذ 1999 في موسكو حيث حصل على الدكتوراه في الترجمة عام 2010. وقد تنوعت مسيرته بين الصحافة الثقافية، إعداد البرامج، كتابة السيناريو، والترجمة الأدبية، فضلاً عن إبداعه في القصة والرواية.
منذ مجموعته الأولى أقفال (2006)، مروراً بـ الوافد (2012) وأنا والجدة نينا (2015)، وصولاً إلى بوصلة السراب، أثبت الرحبي قدرته على المزج بين المحلي والعالمي. ويعزز هذا المسار نشاطه الملحوظ في الترجمة من الأدب الروسي، حيث نقل إلى العربية نصوصاً لتشيخوف وغوركي وغيرهما، كما أسهم مع زوجته المترجمة الروسية فكتوريا زارتوفسكايا في نقل أعمال أدباء عرب بارزين، مثل نجيب محفوظ، إلى الروسية.
هذا الانفتاح الثقافي العابر للحدود انعكس بوضوح في بوصلة السراب، التي قدّمت صورة قرية عُمانية مطلع تسعينيات القرن الماضي، من خلال منظور طفل في الثانية عشرة من عمره. ورغم بساطة السرد الظاهرية، فإن الرواية تكشف عن عمق في الرؤية، وثراء في التفاصيل، وحضور للهوية العُمانية في إطار عالمي. فهي تجمع بين استبطان الحياة القروية بخصوصيتها الاجتماعية والثقافية، وبين مساءلة الهوية بمنظور كوني رحب.
وتتجلى في الرواية جماليات السهل الممتنع، حيث اعتمد الرحبي تقسيم الفصول بعناوين دالة، وتوزيع الخيوط السردية بتأنٍ مدروس يحافظ على عنصر التشويق. كما أضفى منظور الطفل محمد طابعاً اكتشافياً على الأحداث، مجسداً تحولات الشخصية من الانبهار والقلق إلى النضج والتصالح مع الذات.
إلى جانب ذلك، اهتمت الرواية برصد تنوع المجتمع القروي العُماني، عبر العادات والتقاليد، التباينات الاجتماعية والعرقية، وتعدد اللهجات والثقافات المتداخلة، بدءاً من البدو والغجر إلى الوافدين الباكستانيين والإيرانيين. هذا التنوع أضفى على النص بعداً إنسانياً واسعاً، وأكسبه ثراءً لغوياً يتراوح بين الفصحى والمحكية والأمثال الشعبية والأهازيج التراثية.
كما عكست الرواية، من خلال تفاصيل هامشية لكنها دالة، أصداء حرب الخليج الأولى (1990-1991) وما رافقها من ارتباكات اجتماعية وسياسية، مثل غياب والد محمد الذي التحق بعمل عسكري مرتبط بالحرب. هذا الحضور غير المباشر للحدث السياسي منح الرواية بعداً تاريخياً إضافياً، وربط مصير الشخصيات الفردية بسياق إقليمي أوسع.
وفي المحصلة، تمثل بوصلة السراب امتداداً لتجربة الرحبي الإبداعية، وتعبيراً عن مسعاه لبلورة خطاب روائي يمزج المحلي بالعالمي، والهوية العُمانية بالبعد الإنساني الأرحب. وهي نموذج لوعي جديد يفتح الرواية العُمانية على آفاق العالمية، دون أن يفقدها جذورها المتأصلة في الأرض والإنسان والتاريخ.