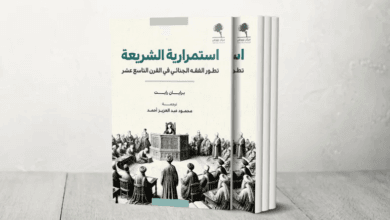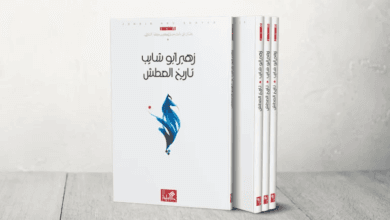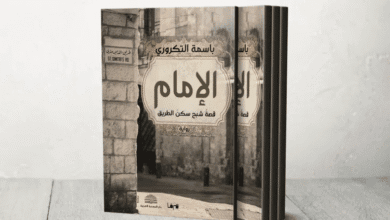العمارة العسكرية في المغرب.. جماليات منسية وتاريخ ينتظر من يكتبه

تُعدّ العمارة العسكرية في المغرب من أبرز أنماط العمارة التاريخية التي تحمل في طياتها بعدًا جماليًا ووظيفيًا فريدًا، وقد لعبت دورًا محوريًا في تشكيل البنية الحضرية والدفاعية للمدن المغربية، ولا سيما مدينة فاس، التي ما تزال تحتفظ بمعالم معمارية عسكرية شاهدة على فترات مفصلية في التاريخ المغربي.
فاس.. شاهد على العمارة العسكرية
تتجلى العمارة ذات الطابع العسكري في مدينة فاس في مجموعة من المعالم مثل “باب الجيسة”، و”باب المحروق”، و”باب القصبة القديمة”، و”باب الحديد”، و”باب الفتوح”، إلى جانب “قصبة الشراردة” و”قصبة تمدارت”، وغيرها من المباني التي تعكس مدى الأهمية الدفاعية لهذه المدينة التي شكّلت مركزًا استراتيجيًا عبر عصور متعاقبة.
ولا تقتصر هذه العمارة على فاس وحدها، بل نجدها منتشرة في مدن مغربية أخرى كانت بمثابة عواصم سياسية أو عسكرية في مراحل مختلفة، ما يثبت أن هذا الطراز المعماري ليس محض صدفة، بل جزء من استراتيجية عمرانية متكاملة.
إهمال تاريخي وفجوة بحثية
رغم أهمية هذه العمارة، فإنها لم تنل ما تستحقه من الدراسة والبحث العلمي. فغياب التكوين الأكاديمي المتخصص في تاريخ العمارة داخل الجامعات المغربية، وخاصة في أقسام التاريخ والآثار، أدى إلى تهميش منهجي لهذا الإرث، لصالح مواضيع أكثر رواجًا مثل التاريخ السياسي أو الاجتماعي.
ويعود هذا التهميش أيضًا إلى غلبة الطابع الشفوي على الثقافة العربية، ما أدى إلى ضعف التوثيق البصري والتحليلي للفنون والعمارة مقارنة بالمجالات الأخرى.
بين المؤرخ والأثري.. تقاطع لا بد منه
البحث في العمارة العسكرية يتطلب تضافر جهود المؤرخين والأثريين، إذ يستند الأثري إلى المصادر التاريخية لتفسير المعطيات الميدانية مثل اللقى والتحف، في حين يحتاج المؤرخ الفني إلى المعطيات الأثرية لدراسة الطرز والنقوش والوظائف المعمارية.
ويُعد هذا التكامل نتيجة لتحول في الفكر التاريخي منذ نشوء “مدرسة الحوليات”، التي وسّعت مفهوم الوثيقة التاريخية ليشمل الآثار، والصور، والنقوش، وحتى السينما والأدب، وهو ما أتاح للمؤرخ أدوات جديدة لقراءة التاريخ، بعيدًا عن السرد التقليدي القائم على الحوادث فقط.
خصوصيات العمارة العسكرية في فاس
بحسب الباحث منير أقصبي، فإن فاس تحتفظ اليوم بثلث ما شُيّد فيها من تحصينات عسكرية، يعود أقدمها إلى العصر الموحدي، وأحدثها إلى فترة الاستعمار الفرنسي. وتتنوع هذه المعالم من حيث الشكل والوظيفة، فنجد أبوابًا ذات مداخل مباشرة وأخرى ملتوية، وأبراجًا مستطيلة أو نجمية، بأسوار سميكة صُممت بغرض الصمود والمناعة، لا الزخرفة.
ويُشير أقصبي إلى ضرورة توظيف هذه الأبراج والقصبات في مشاريع تنموية وثقافية، كمثل “برج سيدي بونافع” و”برج بوطويل”، مع تأهيل مواقع أخرى مثل “قصبة مولاي الحسن” التي تحتاج إلى إفراغها من قاطنيها الحاليين لإطلاق مشاريع ترميم جادة.
أطلال تنطق بالتاريخ
رغم جهود الترميم المحدودة، تبقى العديد من الأسوار والقصبات مجرد أطلال تثير في الباحث أسئلة حول أصولها وتاريخها وجمالياتها. لكن هذه الأطلال، بما تحمله من شواهد عمرانية متفرقة، تمنح العمارة العسكرية في المغرب بُعدًا مركبًا، يختلط فيه الجمالي بالوظيفي، والتاريخي بالفني.
حاجة إلى كتابة جديدة
لقد حظيت أنماط معمارية أخرى، كالدينية منها، بدراسات وافية، إلا أن العمارة العسكرية ما تزال تُعامل كمجال هامشي، في حين أنها تمثل مرآة دقيقة لفترات الحروب والدفاعات والتخطيط الحضري. وما لم يُكتب عنها برؤية علمية متعددة التخصصات، فإنها ستظل حبيسة الإهمال، رغم ما تختزنه من رموز ودلالات عميقة.
إن العمارة العسكرية ليست فقط حصونًا وأسوارًا، بل شواهد على تاريخ من الصراع والسيادة والتنظيم، تنتظر من يعيد قراءتها بنظرة علمية تستلهم من الماضي وتخدم الحاضر والمستقبل.