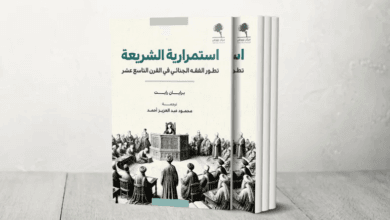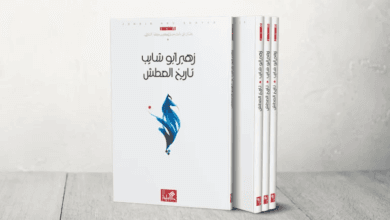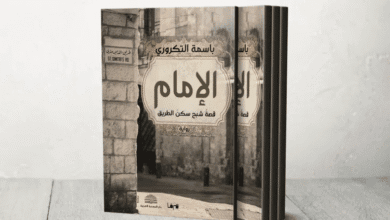أصول النظام الاجتماعي في الإسلام.. مشروع الطاهر بن عاشور لتأصيل نظرية العمران الإسلامي

يُعدّ كتاب “أصول النظام الاجتماعي في الإسلام” للشيخ محمد الطاهر بن عاشور من الأعمال النادرة التي خصصت لدراسة الاجتماع الإسلامي كنسق مدني متكامل، لا كفرع تابع للفقه أو الأخلاق. فالكتاب يسعى إلى بناء تصور شامل للنظام الاجتماعي الإسلامي، منطلقًا من النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة، مع استيعاب متطلبات الاجتماع الإنساني الحديث.
باستثناء مقدمة ابن خلدون التي تُعد النص المؤسس لعلم العمران، يكاد هذا العمل يكون من القلائل في التراث الإسلامي التي طرحت مشروعًا اجتماعيًا متكاملاً. وقد جاء في النصف الأول من القرن العشرين، في زمن كانت فيه المجتمعات الإسلامية تمر بتحولات جذرية تحت تأثير الاستعمار وأسئلة النهضة.
صدر الكتاب مؤخرًا بنسخة منقحة عن مدارات للأبحاث والنشر، ويقع في نحو 240 صفحة تضم تصور ابن عاشور لنظام العمران الإسلامي، مستندًا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وفقه المقاصد، في محاولة لتأصيل رؤية حضارية للمدنية الإسلامية.
الإسلام كدين مدني
ينطلق ابن عاشور من تمييز جوهري بين مرحلتي مكة والمدينة؛ فالأولى ركز فيها الوحي على بناء الفرد إيمانيًا وأخلاقيًا، بينما شهدت الثانية تأسيس الدولة وتنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية. ويرى أن هذا التدرج دليل على أن الإسلام دين مدني في جوهره، يسعى إلى تنظيم الاجتماع الإنساني على أسس من العدل والمصلحة العامة.
الحرية والعقل أساس العمران
يؤكد ابن عاشور أن صلاح العمران مرهون بصلاح الأفراد، وأن إصلاح الأفراد يبدأ من إصلاح عقولهم، لأن الفكر السليم هو منطلق السلوك القويم. وقد خصص فصلًا بعنوان “إصلاح التفكير والتجديد في العقل الإسلامي” لتوضيح رؤيته في تجديد الوعي الديني وبناء عقل نقدي حر.
ويرى أن الحرية إلى جانب الأخوّة تشكلان ركيزتين أساسيتين للعمران الإسلامي؛ فالحرية شرط للمسؤولية والتكليف، وهي في جوهرها مقصد شرعي لا يُقيّد إلا بحدود الضرورة. ويعتبر ابن عاشور أن تقييد الحرية ظلم يؤدي إلى فساد النظام، وأنها أثقل ما يرهق الظالمين، لأنهم يخشون وعي الناس واستقلال إرادتهم.
نظرية في العقد الاجتماعي الإسلامي
يبلور ابن عاشور ما يمكن تسميته بـ”العقد الاجتماعي الإسلامي”، القائم على توازن بين الدولة والأمة، ويتألف من أربعة أطراف:
- الدولة (الراعي)، التي تُقيم العدل وتنظم شؤون المجتمع.
- أهل الرأي والاختصاص، الذين يقدّمون المشورة والنصح.
- الرعية، مصدر الشرعية، سواء عبر الاختيار المباشر أو التمثيل النيابي.
- أهل الذمة، مواطنون كاملو الحقوق، تكفل لهم الشريعة حرياتهم الدينية والمدنية.
بهذا المفهوم، يجمع ابن عاشور بين مرجعية الشريعة ومبدأ المشاركة الشعبية، ما يجعل الدولة الإسلامية أقرب إلى ديمقراطية بمرجعية دينية، لا استبدادية باسم الدين.
قراءة متجددة للجزية والتعدد الديني
يقدّم ابن عاشور قراءة جديدة لفكرة الجزية، فيراها ضريبة مدنية ذات بعد عسكري، تُفرض مقابل الإعفاء من الخدمة القتالية، لا عقوبة على اختلاف الدين. ويكشف هذا الفهم عن مرونة الاجتماع الإسلامي وقدرته على احتضان التنوع الديني والثقافي ضمن إطار جامع.
عوامل انهيار الاجتماع
يحذر ابن عاشور من عاملين يؤديان إلى تدهور الاجتماع:
- التضييق على الحرية، لأنه يشل الإرادة الجمعية.
- سوء استعمال السلطة، عبر كثرة الضرائب والعقوبات، مما يخلق نقمة شعبية واضطرابات داخلية.
ويقترب في ذلك من نظرية ابن خلدون في دورة العمران، لكنه يصوغها بلغة معاصرة تبرز أثر السلطة في تحقيق الاستقرار أو التدهور.
“السلطان النفسي” للإسلام
يتوقف ابن عاشور عند ما يسميه “السلطان النفسي للإسلام”، أي قوته المعنوية والأخلاقية في النفوس، وهو ما يقابل في مصطلحات العصر “القوة الناعمة”. فقد انتشر الإسلام – كما يرى – بفضل القدوة والسلوك قبل السيف، مما يبرز أهمية الصورة الذهنية والسلوك الأخلاقي في بناء النفوذ الحضاري.
منهج المؤلف وفرادة المشروع
يبرز في الكتاب تداخل شخصيتين في ابن عاشور: الفقيه الراسخ في علوم الشريعة، وعالم الاجتماع الذي يقرأ النص في ضوء الواقع. وقد مكّنه منهج المقاصد من تجاوز ظاهر النصوص إلى مقاصدها، مما أتاح قراءة مرنة للنظام الاجتماعي الإسلامي.
وفي النهاية، لا يقدم الكتاب معالجة فقهية جزئية، بل مشروعًا متكاملًا لتأصيل رؤية مدنية للإسلام تقوم على الحرية، والعدالة، والأخوّة. وهو جهد يوازي مشروع ابن خلدون في العمران، لكنه يتقدمه في صياغة “عقد اجتماعي إسلامي” معاصر، يجعل من الإصلاح الفكري مدخلًا إلى إصلاح العمران، ومن الاجتماع الإنساني ساحة لتحقيق مقاصد الشريعة.